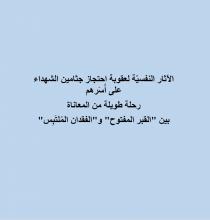الآثار النفسيّة لعقوبة احتجاز جثامين الشهداء على أُسَرهم
رحلة طويلة من المعاناة
بين "القبر المفتوح" و"الفقدان المُلتَبِس"
حسام كناعنة
معالج نفسي
المركز الفلسطيني للإرشاد
ملخّص
تهدف هذه الورقة إلى مناقشة الآثار النفسية للعقوبات الجماعية والتي تأخذ أشكالًا متعدّدة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بأساليب وطرق متنوعة، وستبحث بشكل خاص الآثار النفسية المترتّبة على سياسة/ عقوبة "احتجاز جثامين الشهداء" على أسرهم والعقوبات المرافقة لها، مثل هدم أو التهديد بهدم منزل عائلة الشهيد، ومداهمة المنزل، واعتقال أقرباء الشهيد وسحب الهُويّات وتصاريح الإقامة والعمل وغيرها، وفرض شروط على جنازاتهم؛ حيث إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين لفترات متفاوتة، والتركيز هنا سيكون على أولئك الشهداء الذين تمّت مصادرة جثامينهم واحتجازهم منذ تشرين الأوّل 2015 في ثلّاجات الموتى، وبعضهم تمّ نقله لاحقًا للدفن فيما يُعرف بـ "مقابر الأرقام". ما يميّز تجربة أهالي هؤلاء الشهداء، نتيجة لهذه السياسة ولِما يحيطها من مخاوف ومن عدم وضوح ومن غياب "يقين الموت" ذاته، هو عدم القدرة على إغلاق دائرتَي الحزن والحداد، وبالأحرى عدم القدرة حتّى على البدء بهما.
ترتكز هذه الورقة على منهجية البحث الكيفي وذلك من خلال المقابلة المعمّقة مع ذوي الشهداء، للتعرف على تجاربهم في "الثَكْل" وفي "الفقدان"، بالإضافة إلى مقابلة عدد من العاملين النفسيين للتعرّف على استراتيجيات التدخّل المختلفة مع عائلات الشهداء، كما تمّ الاعتماد على مراجعة الشهادات والتقارير المكتوبة والمرئية والروايات الذاتية والأبحاث المتعلّقة بهذه العقوبة.
في الإطار النظري ستتطرّق هذه الورقة البحثيّة إلى "الفقدان المُلتبِس" كمفهوم يساعدنا على فهم ما يميّز الفقدان مع عقوبة "احتجاز جثامين الشهداء"، وستركّز على خصوصيّة الحالة الفلسطينيّة بأبعادها المختلفة والّتي تتجلّى بـ "مراحل الوجع" وبالصدمات المتتالية لأسر الشهداء، بدءًا بتلقّي نبأ الاستشهاد، ثمّ صاعقة احتجاز جسد الشهيد، يليها ألم تسلّم الجثمان، و"تنتهي"، بعد أن تبدأ الأسرة بمحاولة العودة إلى الحياة الطبيعيّة مع إغلاق قبر الشهيد،عندما تقوم سلطات الاحتلال بإرسال ملابسه إلى العائلة، وهي بذلك كأنّها تفتح القبر مجدّدًا وتنكأ جراحًا لم تلتئم بعد.
ف
المقدّمة
منذ بداية هبّة القدس الأخيرة وانتفاضة الشباب الفلسطيني بشكل عام، والمقدسي بشكل خاص، في تشرين الأوّل من العام 2015، عاد ليطفو على السطح، وبقوّة، موضوع استعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى دولة الاحتلال الاسرائيلي. هذا الموضوع، أي استعادة الجثامين، تمّ مأسَسته عندما تمّ الإعلان عن حملة استرداد جثامين الشهداء والمفقودين الفلسطينيين والعرب في أيار عام 2008، بعدما توجّه والد الشهيد مشهور العاروري لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بطلب المساعدة لاستعادة جثمان ابنه المحتجز منذ نهاية السبعينات فيما بات يُعرف بـ "مقابر الأرقام"، وما زال 253 جثمانًا محتجزًا في هذه المقابر؛ وفي جلسة لمجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، أُقرّ يوم 27 آب من كلّ عام يومًا وطنيًا لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب. لكن المختلف الآن، أي منذ الهبّة الأخيرة، هو أنّ سلطات الاحتلال، بقرار من المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت" بتاريخ 13/10/2015، عادت لممارسة سياسة احتجاز جثامين الشهداء، بعد أن توقّفت عنها لفترة ما، في ثلّاجات التجميد، فتحرّكت "لجنة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم"، وهي لجنة شعبية، للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزين، ولنقل صوت الأهالي ومعاناتهم جرّاء هذا الاحتجاز. لقد بلغ عدد الجثامين المحتجزة في ثلاجات التبريد لدى الاحتلال منذ العام 2015 أكثر من 230 شهيدًا وشهيدة لفترات زمنية مختلفة، ما زال الاحتلال يحتجز منهم 50 جثمانًا حتى اليوم (نهاية أيلول 2019).
إنّ احتجاز جثمان الشهيد، بالإضافة إلى أنّه عقاب لأسرته ولعائلته، هو أيضًا انتقام من الشهيد وممّا يمثّله، وهو تمثيل وتنكيل بجسد الشهيد، عبر العبث به وسرقة أعضاءٍ منه (عودة الله، 2016؛ عليّان، 2018)، بهدف السيطرة على الفلسطيني في حياته وفي مماته؛ فـ "ممّا لا شكّ فيه أنّ احتجاز الجثامين هو وسيلة تستخدمها إسرائيل من أجل تأكيد سيادتها وسيطرتها على الأرض وعلى الجسد الفلسطيني/ة، حيًّا كان أو ميّتًا" (ظاهر- ناشف، 2016. ص. 19)، وبهدف الانتقام أيضًا؛ "الانتقام من المقاوم بالتمثيل بجثّته عبر احتجازها لفترة تتغيّر خلالها طبيعتها، إنّما يعود إلى سببٍ نفسيٍ جوهرُه الشعور الصهيونيّ بالعجز، حين يتعطّل عمل الأجهزة العقابيّة (المخابرات والجيش ومصلحة السجون) إزاء المقاوم لحظة استشهاده (عودة الله، 2018).
إنّ معاناة أهالي الشهداء، المحتجزة جثامين أبنائهم وبناتهم، بشكلٍ عام، وأولئك المحتجزة جثامين شهدائهم في ثلّاجات التجميد، بشكلٍ خاص، لا توصف، والتي يمكن تلخيصها، كما قال أحد الآباء الثاكلين، بأنها "رحلة عذاب لا تنتهي". إنّ حياة هؤلاء الأهالي، أُسر الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلّاجات التجميد، "معلّقة" بمصير أبنائهم وبنتاتهم، و"مجمّدة" لحين تحرير هذه الجثامين لتُوارى الثرى، في سلامٍ وكرامة، حتّى تطفئ لهيب الثلاجة وتُخمد النار المشتعلة حرقةً في قلوب أمّهاتهم وأُسرهم.
تجدر الإشارة هنا إلى أنّه منذ أن بدأتُ هذا العمل، مع منتصف شهر آب الماضي، ارتفع عدد الشهداء المحتجز جثامينهم في ثلّاجات الاحتلال بأربعة شهداء، من بينهم شهيد طفل وآخر أسير وآخر ما زال الاعتقاد السائد لدى عائلته بأنه كان حادث طرق عادي، وأيضًا شهيدة أعدمتها شرطة الاحتلال بدم بارد على حاجز قلنديا، وتمّ الإفراج عن ثلاثة جثامين، وهم جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي من العيزريّة وجثمان الشهيد عمر يونس من قلقيلية، وأيضًا جثمان الشهيد محمّد فوزي عدوي من مخيّم بلاطة، ليصل بذلك عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ تشرين الأوّل 2015 إلى خمسين شهيدًا وشهيدة. في الأثناء، كان قد صدر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، في ملف احتجاز الجثامين (المرفوع أمامها منذ تاريخ 17/7/2017)، ووفق هذا القرار أجازت المحكمة للقائد العسكري للاحتلال صلاحيّة احتجاز جثامين الشهداء ودفنهم مؤقّتًا في انتظار التفاوض لصفقة تبادل أسرى. إن تحويل الجثامين من الثلّاجات إلى "مقابر الأرقام" هو أحد السيناريوهات التي يخشاها أهالي الشهداء، كما عبّر عن ذلك شقيق الشهيد مصباح أبو صبيح، لأن هذا يعني أنّ الاحتجاز أصبح إلى أجل غير مسمّى، بالإضافة إلى ما يسمعه وما يعرفه الأهالي عن هذه "المقابر" وعن طريقة الدفن التي تتمّ فيها، وهذا يشكّل لديهم كابوسًا إضافيًا، حيث إنّ مصير الجثمان يصبح عرضة للضياع، إمّا بالانجراف، أو بتعرّضه للنبش وللنهش من قبل الحيوانات الضارية، التي تعبث في تلك المقابر (تقارير صحفيّة إسرائيلية مختلفة، موثّقة في عليّان، 2018).
إضافة إلى ذلك، فإنّ صدور هذا القرار، يوم 10/9/2019، لم يلقَ الاهتمام المطلوب من قِبل الرأي العام أو من قِبل المستوى الرسمي، ومرّ كأي خبر عادي، الأمر الذي شكّل خيبة أمل كبيرة لدى عائلات الشهداء وأشعرها بالعجز وبالضياع، لأنّ المَهمّة أصبحت أكبر من أن تستطيع تحمّلها أي فئة على عاتقها الفردي وتتطلّب جهودًا مشتركة، شعبية وأهليّة/ مؤسّساتية ورسمية، لتقييم أداء المرحلة السابقة ووضع خطّة عمل جديدة والتوجّه إلى المؤسسات الدولية ذات الشأن.
المنهجيّة
في هذه الورقة البحثيّة اعتمدتُ أسلوب البحث الكيفي وذلك من خلال المقابلة المعمّقة مع ذوي الشهداء ومع أبناء عائلاتهم، من خلال طرح أسئلة مفتوحة، للتعرّف على تجاربهم الخاصة في "الثّكْل" وفي "الفقدان والحداد"، وتعمّدتُ أن أسمع منهم مباشرة دون أن ألتزم بإملاءات النظريات النفسية أو بالنماذج المختلفة للفقدان ولمراحله، حيث كنت أُخبر الأهالي عن هدفي من المقابلة وأترك لهم الكلام؛ حيث إنّ ما كان يُشغلُني هو محاولة فهم موضوع البحث انطلاقًا من المشاركين (كناعنة، ونتلاند، 2003). لكن، وقبل أن أبدأ بمقابلاتي، ومنذ أن طُلِب مني إعداد هذه الورقة، كنت أتساءل قلقًا عمّا إذا كانت مقابلاتي هذه مع أهالي الشهداء ستفتح جروحًا أو تقلّب المواجع والآلام، أو أنّها قد تُسبّب ضررًا نفسيًا، بشكلٍ أو بآخر، كما طرح كناعنة ونتلاند (2003): "علينا بهذا الخصوص ألا ننسى أنّه في تعاملنا مع أعماق النفس البشرية الجريحة فإنّ ما لا ينفع، ليس فقط لا ينفع، بل يمكن أن يضرّ ويهدم ويحطّم" (ص 10). هنا جاءني الجواب من أكثر من جهة ومن مصدر؛ ففي بداية البحث أجريت مقابلاتٍ مختلفة مع عددٍ من الزملاء ومن الزميلات في "المركز الفلسطيني للإرشاد"، في مواقعه المختلفة، الذين تدخّلوا مع عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، وقد أكّدوا لي على أنّ الأهالي يُريحهم أن يتحدّثوا عن الموضوع، رَغم الألم المرافق له، وقد أشاروا إلى أنّ الجراح لم تلتئم أصلًا، وبقيت مفتوحة، لذلك، كما قالوا، فإنّك لن تنكأ جراح أحدٍ. إنّ الحديث عمّا جرى هو ما تشترك به نماذج التدخّل في علاج الطوارئ والحالات الصدميّة (سعيد، ودقدوقي، 2013)، وتؤكّد اسبانيولي وعويضة (2007، ص. 66) على أنّ "الحديث عن الصدمة وإعادة سردها من أهمّ مقوّمات فهم الحَدث، إذ إنّه يجعل كلّ فردٍ قادرًا على أن يتأمّل من جديد ويراجع ويتفهّم المصيبة التي حدثت معه. وهذا بحدّ ذاته عاملاً مهمًا للخروج من الأزمة حسب النظرية السردية "Narrative Therapy".
أمّا التأكيد الآخر، الذي طمأنني إلى أنّني أستطيع أن أجري هذه المقابلات مع الأهالي دون أن أزعج أو أن أؤذيَ أحدًا، فقد جاءني من المقابلة الأولى والتي أجريتها مع الناطق بلسان "لجنة أهالي الشهداء"، وأحد الآباء الثاكلين والذي احتجزت سلطات الاحتلال جثمان ابنه الشهيد لأحد عشر شهرًا في ثلاجات التجميد، السيّد محمد عليان والد الشهيد بهاء، وزوّدني بأرقام الأهالي الذين تواصلت معهم لاحقًا. لقد شكّل لي عليّان "المفتاح"، أو ما يُعرف في البحوث الاجتماعية الكيفية بـ Gatekeeper (Broadhead & Rist, 2010)، خصوصًا في المواضيع الحسّاسة، الذي من خلاله استطعت الدخول إلى أسر الشهداء لإتمام مقابلاتي لهذا البحث، وهذا كان يطمئن المشاركين في البحث ويجعلهم يتحدّثون بأريحية حتّى عن أمورٍ خاصّة جدًا، لم يشاركوا بها أحدًا من قبل.
لقد قابلت، من أجل إتمام هذه الورقة البحثيّة، ستّ عائلات من منطقة القدس ومحيطها، بعضها كان يشمل العائلة ككل، والبعض الآخر كانت المقابلة فقط مع الأب أو مع الشقيق، أومع أبناء وبنات العمّ، وإحداها كانت تضمّ الوالد مع أقربائه وأنسبائه ومع أطفاله الصغار. المقابلة الأولي التي أجريتها، مع عليّان كما ذكرت سابقًا، كانت بناءً على توصيات زملائي في المركز الفلسطيني للإرشاد، وهي المقابلة التي منها بدأت "كرة الثلج" بالتدحرج، فعندما كنت أتصل بالأهالي وألتقي بهم وأخبرهم إني من طرف "أبو خليل" كانوا يطمئنّون ويتعاونون معي، وكانوا عادة ما يسألونني، عند نهاية المقابلة، مع مَن التقيت مِن قبل ومَن أنوي مقابلته بعد، وكانوا يشجّعوني على الاستمرار. من الجدير ذكره هنا أن الجو غير الرسمي، نتيجة ما ذكرته سابقًا، أضفى أريحيّة وانفتاح في المشاركة المشاعريّة من قبل الأهالي.
في هذه الورقة البحثية، بالإضافة إلى الاعتماد على المقابلة المعمّقة مع عائلات الشهداء، كمصدر للمعلومات، فقد اعتمدت أيضًا على مقابلة عددٍ من الزملاء ومن الزميلات العاملين النفسيّين، خاصة من المركز الفلسطيني للإرشاد، ومن مركز الدراسات النسوية في نابلس، العاملات ضمن مشروع الدعم النفسي المتبادل و"نهج من فاقدة لفاقدة"، وذلك من أجل التعرّف على الآثار النفسية التي لاحظوها وسجّلوها خلال تدخّلاتهم مع عائلات الشهداء ومع النساء الفاقدات.
كما أنّني اعتمدت على مراجعة الشهادات والتقارير والمقابلات المكتوبة والمسموعة والمرئية، والروايات الذاتية لعائلات الشهداء، بالإضافة إلى مراجعة عددٍ من الأبحاث ومن الأدبيات المتعلّقة بحجز جثامين الشهداء كعقوبة جماعيّة لأسرهم، والآثار النفسية المترتّبة على هذه العقوبة.
الآثار النفسيّة للعقوبات الجماعيّة
العقوبات الجماعيّة: "ينصّ القانون الدولي الإنساني على عدم معاقبة أي شخص عن مخالفة لم يرتكبها. كذلك يحظر القانون تطبيق عقوبة جماعية على مجموعة أشخاص عن جرم ارتكبه شخص آخر، سواء كانت هذه الحالة تتعلّق بأسرى الحرب أو بأشخاص آخرين (اتفاقيّة جنيف 3، المادة 87، البروتوكول 1، المادة 75-2، البروتوكول 2، المادة 4-2 ب). وهذه إحدى الضمانات الأساسية التي تنصّ عليها اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاتها الإضافيان لعام 1977. وهذه الضمانة لا تشمل الأشخاص المحميين فحسب، بل تشمل جميع الأفراد بغض النظر عن مكانتهم أو تصنيفهم كما هو مبين في اتفاقيات جنيف (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 33)" (منظمة أطباء بلا حدود).
يتمثّل العقاب الجماعي في عقاب أفراد وعائلات ومجتمعات وأحياء وقرى ومخيّمات ومدن ومناطقَ بأكملها على فعلٍ قام به فرد أو مجموعة أفراد، وهذا العقاب يكون فقط جرّاء انتماء المُعاقَبين لفئة معيّنة؛ جرّاء انتمائهم لشعب أو لبلد أو لحيّ أو حتّى لعائلة، بمعنى أنّ هذه العقوبات الجماعيّة هي ليست فقط عقاب فرد أو أفراد لعمل لم يرتكبوه، وإنما المعاقبة هنا هي لمجرّد الانتماء القومي أو المكاني أو العائلي. من هنا، فإنّ الاحتلال بحدّ ذاته هو عقابّ جماعيّ للشعب الفلسطيني بأكمله، وكل ممارسات الاحتلال وما ينتج عنه هو أيضًا يندرج ضمن العقوبات الجماعيّة الموجّهة ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني لمجرّد انتمائهم لهذا الشعب ولهذا المكان، فلسطين.
من الصعب أن نحصر أشكال العقوبات الجماعيّة التي يمارسها الاحتلال ضدّ الإنسان الفلسطيني، لكنّها تتجلّى بممارسات وأشكال وسياسات مختلفة ومتعددّة من قِبل الاحتلال ومستوطنيه، بدءًا بوجود الاحتلال، وهو الاحتلال الأطول في التاريخ المعاصر، ومرورًا بحصار غزة، وبمصادرة الأراضي والمواشي والآليّات الزراعية وغيرها من الآليّات، وبالاستيطان، وبسرقة المياه، وبقطع التيّار الكهربائي، وبمنع التجوّل، وبمنع تصاريح العمل، وبتقييد حريتَي الحركة والعبادة، وبالإغلاقات، وبالاجتياحات، وبعدم منح تصاريح البناء، وبهدم المنازل والمنشآت، وبإتلاف المحاصيل وحرقها، وباقتلاع الأشجار، وبالجدار، وبحواجز التفتيش، وبالمداهمات الليلة والنهارية، وبالاعتقالات، وبسحب الهُويّات، وبمنع الإقامة، وبتوقيف لمّ الشمل، وبالإبعاد والتهجير القسريّ، وبقرصنة أموال الضرائب، وباحتجاز البضائع والبريد، وباحتجاز جثامين الشهداء، والقائمة تطول. إنّ هذه الممارسات "تؤثّر على جميع الفئات السكانيّة، بما فيهم الأطفال والنساء والمسنين، ممّا يخلق حالة من انعدام الأمن والأمان، وممّا يحدّ بشدّة من فرص تطوير المجتمعات الفلسطينية" (حسنين، 2015، ص 6)، ويحدّ أيضًا، من قدرة الإنسان الفلسطيني على أن يحقّق ذاته وطموحاته.
إنّ الهدف من العقوبات الجماعيّة التي يمارسها الاحتلال، والتي يشكّل أغلبها أعمالًا انتقاميّة ذات طبيعة ثأريّة (قَبَليّة)، هو ليس فقط السيطرة على الشعب الفلسطيني وعلى مقدّراته وموارده، وإنّما أيضًا إخضاعه وإذلاله؛ فـ "إلى جانب الحصار العسكري والنفسي والاقتصادي المفروض على المواطنين الفلسطينيّين، وظروف الجوع والفقر، هناك جانب غير مرئي يمارسه جنود الاحتلال بشكل مقصود (وأُضيف، بشكلٍ مدروس)، بحقّ السكان، هو ممارسة الإذلال بشتّى صوره. فالشخص الذي يسعى للبحث عن لقمة الخبز ليدفع عن نفسه وعائلته غائلة الجوع، ولا همّ له إلا تأمين حاجاته الأساسية، ويلقى هكذا معاملة مذلّة، يتحوّل من إنسان سويّ يفكّر في تحسين وضعه ومكانته في عينه وعيون الآخرين، إلى إنسان أقصى طموح له هو البقاء على قيد الحياة. وبمعنى آخر تصبح ردود فعله فطريّة غير متوازنة، لا مكان للعقل فيها" (سرور، 2002، ص 31). العقوبات الجماعيّة، هنا، تقصد تحطيم الذات، والكينونة الفلسطينيّة، كذات فاعلة، من أجل تحويلها إلى حالة من "اللا حول"، ومن "العجز المُتعلّم" (Learned Helplessness)، الذي وصفه مارتن سيلغمان على أنّه وضع يؤدّي فيه تكرار تعرّض كائن حيّ لعقاب لا يمكن تفاديه إلى تقبّل عقاب لاحق حتى عندما يمكن تفاديه (Martin Seligman, 1975).
إن الإنسان الفلسطيني الذي يبذل جهده للوصول، على سبيل المثال، إلى مكان عمله، أو إلى مبتغاه، الفعلي والمجازي، بنجاح، فإنّه سرعان ما سيكتشف أنّ الجهد المبذول لن يتكلّل بالنجاح، ولن يأتيَ بثماره، لأنّ عسكريًا إسرائيليًا، ذلك الصباح، قرّر أن يغلق "بوابة القرية" أو أن يسدّ الطريق الواصل إلى المدينة القريبة بساترٍ ترابيّ، أو أنّه قرّر إقامة حاجزٍ "طيّار" لم يكن يعلم بوجوده مسبقًا ليتفاداه؛ فالغموض وعدم القدرة على تخطيط أبسط أمور الحياة اليومية والتنبّؤ الدائم بأنّ الأسوأ قادم، كلُّها أمور تقود الفلسطيني للإحساس بأنه ليس مسئولًا عن قدره وبأنّه لا يوجد ما يمكن عمله، ورفض هذا الإحساس وعدم التسليم به قد يكون أحد الدوافع، إن لم يكن الدافع، وراء تمرّد الشباب الفلسطيني في هبّته الأخيرة.
من هنا يمكن القول إنّ "العجز المتعلّم" أو "المكتسب"، خاصة في الحالة الفلسطينية، هو "عندما يصل الإنسان إلى حالة يشعر بأنّ إمكاناته الداخليّة وقواه لا تمكّنه من تغيير الوضع الراهن فإنّ ذلك يشعره بالعجز، ويظهر العجز بالأعراض التالية: 1) انخفاض الحافز، 2) الشعور باللاحول، 3) الشعور بانعدام الأمل، 4) الانتحار" (النشاشيبي، وجحجوح، 2000، ص 13). إنّ السياسات الاستعلائيّة والقمعيّة والانتقاميّة والإذلاليّة التي ينتهجها الاحتلال الاستعماري، في الحياة اليوميّة للإنسان الفلسطيني، تهدف إلى تجريد هذا الإنسان من إنسانيّته (Dehumanize)، وإلى إذلاله (Humiliation)، من أجل تهديم شخصيّته وغرز عقدة النقص فيه وبالتالي السيطرة عليه بسهولة (المصدر السابق، ص 13). هنا أيضًا، على الحواجز ونقاط التفتيش وطوابير الانتظار، أغلبنا كان شاهدًا على كيف أنّ الاحتلال، من خلال عقابه الجماعي و/أو التهديد به، يحاول أن يجعل الإنسان الفلسطيني يقوم بمراقبة نفسه وسلوكه، ومراقبة الآخرين أيضًا وسلوكهم. فالضغط النفسي/التوتّر وحالة الانتظار الّذَين يولّدهما الوقوف يوميًا على حواجز الاحتلال ونقاط تفتيشه، كثيرًا ما يجعلا من البعض منّا أن يؤدّي دور "الرقيب" و/أو "القامِع"، فيقوم بِلَوْم أيّ شخصٍ يجادل الجنديّ الواقف على الحاجز، لأنّه يأخره على عمله، وبدل من أن يصبّ جام غضبه على المحتلّ، الذي هو السبب الأول والأخير للتأخير الحاصل، لوضعه هذا الحاجز، ولوجوده في حياة الإنسان الفلسطيني، فإنّه يصبّه على الفلسطيني الآخر، الذي قد يكون تأخر في إخراج هويّته و/أو تصريحه أو أنّه جادل المحتل في أمرٍ ما.
الرقابة الذاتيّة هي أحد أهداف وضع أبراج المراقبة "خماسيّة الشكل" (Panopticon) (فوكو، 1970) على الحواجز وفي السجون وفي مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينيّة، حيث يكون الإنسان الفلسطيني مرئيًا ومكشوفًا، بينما لا يستطيع هو أن يرى مَن في الأبراج، وأن يرى إن كان هنالك أحد يراقبه بالفعل أم لا، لكنّه يتصرّف وكأنه موجود وبالتالي يضبط سلوكه ذاتيًا.
كما أنّ تجربة الأهالي ذوي الأطفال رهن الاعتقال المنزلي، خاصة في منطقة القدس، الذين يتحوّلون إلى سجّانين لأبنائهم، خوفًا عليهم من إعادة اعتقالهم و/أو من دفع غراماتٍ ماليّة باهظة، لهو مثالٌ آخر على هذا النوع من الرقابة الذاتية، كأداة للضبط وللسيطرة؛ فـ "هناك أمّهاتٍ وقّعْن مرغمات على أن يكنّ شرطيّات في بيوتهن لحراسة أطفالهن الموضوعين تحت الإقامة الجبريّة كما حدث مؤخرًا في القدس، ...، ويكفينا أن نذكر حكاية واحدة منهن عندما قالت إنها انهالت على ابنها (15 عامًا) بالضرب عندما قرّر ترك البيت وهو تحت الإقامة الجبرية بينما كان المستعربون في المنطقة" (عويضة، في حسنين، 2015، ص 4). هذا الدور الذي قد تقوم به بعض الأمهات، والآباء أحيانًا، كرقيب وكحارس/سجّان على الأطفال، ليس فقط أولئك الأطفال رهن الإقامة الجبرية، نابع من قلقهنّ الدائم عليهم، حيث "يصل هذا القلق إلى درجة منعهم من الخروج من البيت خوفًا من أن يصابوا بأذى الجنود، أو خوفًا من أن يتوجّهوا إلى جهات سياسية قد توصلهم إلى أن يكونوا مطاردين، فتشدّد الأم الرقابة على أطفالها ممّا يسبب الاضطراب في العلاقات مع الأهل من جهة، وتقييد الطفل ومنعه من الحركة والتطور السليم من جهة أخرى" (اسبنيولي، وعويضة، 2007، ص 39)، كما قالت إحدى الأمّهات: "أنا اللي بجيب أغراض الدار وما بخلّيهم يطلعوا" (المصدر السابق). لهذه الأجواء، من الرقابة الذاتية ومن قلق وخوف الأمهات، آثار نفسية سلبية كبيرة على النمو النفسي السليم للأطفال، فالطفل "يحتاج إلى جو نفسي-اجتماعي تتوفّر به أبسط الشروط الأساسية الداعمة والقادرة على الإسهام في بلورة هويّته وتطوره السليم. وهذا يتوقّف على توفّر الشروط التي تؤمّن للطفل حرّية الحركة وحرّية اللعب وتشجيع المبادرات" (المصدر السابق، ص. 38-39)؛ هذه الشروط التي لن تتوفّر، بكلّ تأكيد، في ظلّ الرقابة الذاتيّة التي تُمارس على هؤلاء الأطفال.
من هنا يمكننا القول إنّ الهدف من العقوبات الجماعيّة ليس فقط هدم الحجر وحرق الشجر، وإنّما هدم وتحطيم البشر، وتحطيم الذات الفلسطينيّة ككينونة فاعلة وتحويلها إلى حالة من اللاحَوْل، بلا هدف وبلا معنى، وحسب علم النفس الوجودي (Existential Psychology) "لا يستطيع الإنسان أن يكون مرتاحًا وأن يقوم بوظائفه الحياتيّة العاديّة إذا لم يستطع إيجاد معنى وهدف لحياته" (المصدر السابق، ص. 22)؛ والهدف هنا هو تهديم "شبكة الأمان" للإنسان الفلسطيني، التي هي عماد الصلابة النفسية والصمود.
عقوبة احتجاز الجثامين وأثارها النفسيّة على أُسَر الشهداء
بين "القبر المفتوح" و"الفقدان المُلتَبِس"
إنّ عمليّة "احتجاز الجثامين" أو "الاعتقال الإداري للجثامين"، كما تقترح الباحثة سهاد ظاهر- ناشف (2016)، أو "تجميد الموت"، هي عقوبة جماعيّة لأهالي الشهداء، بالإضافة إلى أنّها عقوبة موجّهة ضدّ جسد الشهيد، عبر التنكيل والتمثيل بهذا الجسد بالاحتجاز، كما يوضّح الباحث خالد عودة الله (2015)، لأنّه تمرّدَ ورفض أن ينصاع للواقع المفروض. لهذه العقوبة الجماعيّة آثارٌ نفسيّة وخيمة ومعاناة لا تنتهي، من الصعب وصفها إلّا مِمّن عاشها. وهنا سأحاول فقط الاقتراب من وصف هذه المعاناة وهذه الآثار؛ وحين أقول إنها معاناة لا تنتهي ومن الصعب وصفها، فهذا ليس من باب المبالغة أو المجاز، فيكفي أن نتأمل هذه المفارقة (Paradox) التي سمعتها على لسان إحدى الأمهات الثاكلات، السيّدة أزهار أبو سرور، والدة الشهيد عبد الحميد أبو سرور، لنفهم ما المقصود: "أنا أمنيتي في الحياة أن أدفن ابني"، أيّ أمّ في الدنيا يمكنها أن تلفظ أو أن تتصوّر مثل هذه الأمنية؟! لكنّها أمنيتها، وهي التي عاشت في طفولتها، تجربة فقدان شبيهة، حين استشهد والدها في بيروت بقصف من الطيران الاسرائيلي، وبقي تحت الردم سبعة أيام، ووالدتها ترفض أن تفتح بيت عزاء قبل تسلّم جثمان زوجها. لكن بعد دفن الوالد في مقبرة الشهداء، أوّل شيء اعتادت العائلة القيام به في الأعياد، بعد ارتداء الأطفال لملابس العيد، هو زيارة القبر وقراءة الفاتحة عليه. شقيق الشهيد مصباح أبو صبيح يقول إنّ أمنية والده هو أن يَدفنَ ابنه، مع أنّه من الطبيعي، ومن الفروض، أن يحصل العكس، الابن هو الذي يدفن والده. ويضيف مستهجنًا: "لأي حال وصلنا، صار حلمنا كفلسطينيين اليوم إنّه ندفن اولادنا". أمّا والد الشهيد بهاء عليان فقد كتب يقول، وكرّرها على مسمعي: "أنا ولدت يوم دَفنتُ البهاء"؛ كأنّه يقول لنا إنه عاد إلى الحياة يوم وارى جثمان ابنه الشهيد الثرى في سلام. بينما عبّر والد الشهيد حسن مناصرة عن ذلك بمفارقة أخرى قائلًا "إنّ الشوق لدفن الابن كأنّه ميلاد لابن جديد لك"! وتعبّر والدة أحد الشهداء عن هاجس لا يفارقها قائلة: "بظلني خايفة أصحى من النوم الفجر وألاقي ابني مكَوّم في كيس أسود راميينه قُدّام البيت". زميلة في القدس، ممّن تدخّلن مع إحدى الأسر، أخبرتني عن أحد الأطفال في الصفّ الأول، الذي يرفض الذهاب إلى المدرسة، ويرفض الابتعاد عن البيت، لأنّه خائف من أن يتمّ إعادة جثمان والده الشهيد وهو غائب عن البيت، ولا يتمكّن من توديعه؛ إنّ عودة الطفل إلى المدرسة هو عودة إلى مسار الحياة الطبيعي، لكنّ فقدان الأب وعدم القدرة على توديعه، يمنع إتمام الحداد وإغلاق دائرة الحزن. هذه المعاناة التي لا تنتهي، لخّصها لي شقيق الشهيد مصباح أبو صبيح بِما حدث مع العائلة: "اولاً، نحن لا نملك شهادة وفاة، وبالتالي ابن الشهيد لا يستطيع إصدار بطاقة هويّة، والداخلية طالبته بإحضار والده، فأخبرهم بأنه متوفى، فطالبوه بإحضار شهادة الوفاة، وهم الذين يصدرونها، وهم الذين يحتجزونه. عدم إصدار شهادة الوفاة هو عقاب أيضًا للزوجة، التي لا تستطيع أن تثبت بأنها أرملة للحصول على مستحقّاتها. كان هنالك أيضًا عقاب للأبناء، حيث تمّ اعتقالهم أكثر من مرّة ولفترات طويلة، ممّا منع الابن الأكبر من مواصلة دراسته الجامعية، واعتقلت ابنة الشهيد لمدّة أسبوع، واستجوابات واعتقالات لبقيّة العائلة، من ضمنهم والد الشهيد الذي يبلغ من العمر ثمانين عام، والاعتقال الإداري لزوج ابنة الشهيد يوم زفافه، وتسكير المنزل الذي كانت تسكنه عائلة الشهيد، مع أنّه لا يملكه". لكن الأصعب من هذا كلّه هو عدم يقين العائلة من استشهاد ابنها، ورفض سلطات الاحتلال إعطاء العائلة أي دليل على ذلك، وبالتالي تبقى العائلة مع هذا الغموض، ويبقى السؤال يقضّ مضاجعها، والهواجس ممّا يكون قد حصل للشهيد، والهواجس المتعلّقة في مصير الجثمان: هل بقي في الثلاجة، وهل تمّ العبث به، هل سرقوا أعضاءً منه؛ هذه الهواجس لا تقتصر على عائلة الشهيد أبو صبيح، بل تتشارك بها معظم الأسر، إن لم يكن جميعها.
معاناة لا تنتهي
إنّ هذه المعاناة لا تنتهي طالما بقي القبر/الجرح مفتوحًا، والموت معلّقًا، فيكون من الصعب على أسرة الشهيد ليس فقط أن تغلق دائرتي الحزن والحداد، بل أن تبدأهما كما يجب، فتبقى حياتها معلّقة، ومجمّدة، وباردة، وقلقة ومتوتّرة، إنّها "قصة معاناة لا تنتهي" كما قال والد الشهيد عبد الحميد أبو سرور. في وصفه للحالة التي يعيشها ذوي الشهداء، من تجربته الشخصيّة، قال والد الشهيد بهاء عليان، في مقابلة صحفية لوكالة وطن للأنباء، 01.07.2019، إنها "قاتلة"، وأضاف: "خلال هذه الفترة لم نهدأ يوما واحدًا، ولم نَنم دون كوابيس أو بكاء، نظهر أمام الإعلام برباطة جأش بينما نكون في الحقيقة نتألّم... ولم نشعر في الراحة أو الاطمئنان إلّا عندما دُفن بهاء، وأصبح له عنوانٌ نستطيع زيارته". والد الشهيد يصف المعاناة ويصف الألم، لكنّه لا يتحدّث عن الحزن، وقد أكّد على ذلك، في مقابلته معي، "أنّ لا وقت لأسر الشهداء للحزن وللحداد، فهمّهم هو استعادة جثمان أبنائهم الشهداء"، الأمر الذي سمعته من أسرٍ أخرى قابلتها، فوالد الشهيد حسن مناصرة يقول "إنّ الاحتجاز (متابعته وملاحقته والانشغال به) قد ساعد على تخطّي مرحلة الفقدان". إحدى الزميلات اللواتي تدخّلن مع أسرة شهيد احتجز الاحتلال جثمانه، قالت "إنّ الأسرة، عند تلقّيها نبأ استشهاد الأب/الزوج، لم تكن جاهزة أو مستعدّة لموضوع الفقدان أو الاستشهاد أو حتّى حجز الجثمان"، وعن الشباب في العائلة أضافت: كأنّهم كانوا بين نارين، حيث إنّهم كانوا يشعرون أنه من مسئوليّتهم حماية البيت ومتابعة الدفاع عنه ومنع الهدم القادم، من جهة، واستعادة الجثمان المحتجز، من الجهة الأخرى"، بينما قالت الزوجة، التي كانت خائفة من أن يتمّ هدم البيت، وقلقة من الاعتداءات على الأبناء واعتقالاتهم المتكرّرة، ومن تأثّر دراسة وتعليم الأولاد، "أنا هلأ مش فاضية أحزن، في أمور تشغلني ولازم أنجزها، وفي الجثمان".
عدم الاستعداد للحدث، للاستشهاد ولحجز الجثمان، هو ما يتفق عليه أهالي الأسرى وهو ما يميّزهم؛ فالوالد الذي يصبح "والد الشهيد" بغتة، يجد نفسه يدخل لمعركة استعادة الجثمان، حتّى قبل أن يصحوَ من صدمة/ نبأ الاستشهاد والذي قد يرفضه وينكره في البداية، دون تحضير أو تجهيز أو توجيه، ما يشكَل "صدمة" له، والحياة التي كان يعرفها قبل ذلك تنقلب رأسًا على عقِب، ويدخل في حالة طوارئ ولا يعنيه شيء في الحياة غير موضوع واحد، ألا وهو استعادة جثمان ابنه الشهيد المحتجز لدى الاحتلال. في حالة الصدمة/ البغتة هذه، ليس من المستبعد أو المستغرب أن ترفض أسرة الشهيد أي عرض للمساعدة أو للتدخّل النفسي من مهنيّين مختصّين، مع العلم أنهم قد يحتاجونها، لكن متطلّبات الموقف تحكم تصرّفاتها وسلوكها.
يمكن قراءة حالة الطوارئ هذه من منظور علم النفس السردي (Narrative Psychology)، حيث إنّها "كأيّ أزمة يمرّ بها الإنسان أو المجتمع، هي عبارة عن فترة زمنية فيها نوعٌ من إقصاء الفرد عن قصّته الذاتيّة من ناحية وإجباره على تبنّي قصّة مغايرة. هي حالة إجبار على التغيّير دون توفّر إرادة التغيّير أو الاستعداد لها، لهذا يمكننا أن نسمّي حالة الطوارئ بـ القصة الإجباريّة. الإجبار هنا هو نوع من التّهديد النّفسي ونتيجته الارتباك وفقدان التوازن" (كريّم، 2007، ص 17). والد الشهيد حسن مناصرة يصف حالة الطوارئ هذه، والإجبار المفاجئ على دخول قصة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، بأنها تختلف عن تجربته السابقة في الفقدان، حين توفي ابنه الصغير في حادث عن عمر يناهز السنة، حيث يقول إنه "بالإضافة للفجأة، كان هنالك حجز الجثمان، قصة قلبت حياتنا، فبعد احتجاز الجثمان كل شيء اختلف: العمل، والأصدقاء، والاهتمامات وتعليق كل أمور الحياة. حسن أصبح الأولويّة الأولى في حياتي، هذا كان واجبي تجاه ابني، والذي أنجزته في النهاية، واستعدته بعد سبعة أشهر من الاحتجاز والتجميد، وارتحت، لكن تبقى الغصّة للجماعة الذين كانوا معنا (وما زالوا عالقين)".
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه "الغصّة" ليست وليدة صدفة، فهي تأتي من طبيعة العلاقة التي تشكّلت بين أُسر الشهداء، حيث إنّهم أصبحوا "أسرة وعائلة واحدة كبيرة وقويّة، يجمعها الألم والوجع والعمل المشترك، ولا أحدٌ بها يتوخّى من الآخر أيّ مصلحة شخصيّة، فما يريحنا هو أن نجلس معًا وأن ندعم بعضنا البعض"، هذا ما قاله والد الشهيد بهاء عليّان، وأكّد عليه الآخرون. شقيق الشهيد مصباح أبو صبيح يؤكّد على أنّ أكبر دعم تلقّوه، في ظل غياب الدعم الجماهيري والمؤسّساتي والرسمي، كان من العائلات الثكلى الأخرى، مِمّن مروا بنفس التجربة. لقد عبّرت أكثر من أسرة أنّه لم يعد يريحها أن تجلس مع الآخرين، إن كان من العائلة الممتدّة أو من خارجها، أو المكوث مع أحد من خارج دائرة أسر الشهداء، لأكثر من ساعة، إلّا مع عائلات الشهداء أو عندما يكون الحديث عن موضوع متعلّق بقضية أبنائهم المحتجزين. عندما كنت في مقابلة عائلة الشهيد أبو سرور، لم أنتبِه إلى أنّنا كنا جالسين لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، وقالوا إنّهم أيضًا لم ينتبهوا للأمر ولم يشعروا بالوقت وبكيف أنّه مرّ بهذه السرعة. مع والد عليّان، بعد أن أنهينا المقابلة التي استمرّت لأكثر من ساعتين، قال لي إنّه من النادر أن يجلس مع أحد لهذا الوقت كلّه، إلا مع عائلات الشهداء.
الدعم المتبادل
إنّ الدعم المتبادل الذي بين عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم هو أكبر مصدر قوّة، حتى اليوم، لهم، ويُصبح هذا الدعم ضرورة ملحّة خاصة حينما يتعلّق الأمر بتسلّم جثمان الشهيد المجمّد؛ فمَن مرّ بهذه التجربة يعرف الإجراءات المتّبعة، ويعرف ما المتوقّع أن يحصل، وكيف سيكون الجثمان، ويعرف، أيضًا، كم أنّه من المهم أن يُعطى لأم الشهيد وقتها للتوحّد مع الشهيد، لتتهامس معه وتكلّمه. كما أنّ تجربة الأهالي الذين تسلّموا الجثمان يعرفون كم من المهم أيضًا أن يقوم والدا الشهيد وأهلُه المقرّبون بتوديعه وطبع قبلة على جبينه؛ فبعد مرور أربع سنوات على دفن جثمان الشهيد الطفل معتز عويسات، ما زال والده، الذي حُرم وزوجته من توديع ابنهم لشدّة التشوّهات التي طرأت على الجثمان، يقول لوالد الشهيد بهاء عليّان، كلّما رآه: " نيّالك، انت بوّست بهاء".
هذا الدعم المتبادل، والدعم الذي يقدّمه من مرّ بهذه التجربة لأهالي الشهداء الذين يُصبحون على حين بغتة "أُسرة شهيد" وينكشفون على هذا العالم وهذه المأساة التي في انتظارهم دون تحضير أو تجهيز، هو من أهمّ أشكال الدعم النفسي لهذه العائلات، وهذا النوع من الدعم يتوافق مع التجربة الفلسطينية لمركز الدراسات النسوية والمعروفة بـ "نهج من فاقدة لفاقدة" (اسبنيولي، وعويضة، 2007؛ حسنين، 2010؛ 2014).
اختلاف الموت
الفقدان هنا هو ليس فقط فقدان معلّق أو غير مكتمل، وإنما كثيرًا ما يكون فقدان ممتدّ ومؤجّل، وفقدان يتلوه فقدان، وصدمة تتلوها أخرى، فبالإضافة إلى الفقدان الأوّل، الاستشهاد، هنالك أيضًا احتجاز الجثمان، وفقدان الفرصة لتوديعه، وفقدان البيت والذكريات التي يحتويها، وفقدان أفراد آخرين من العائلة عبر الاستدعاءات والاستجوابات المتكرّرة في مراكز التحقيق لدى الاحتلال، واعتقالهم لفترات مختلفة، كما حدث مع أخ الشهيد حسن مناصرة، ومع أبناء الشهيد مصباح أبو صبيح ومع ابنته، والاعتقال الإداري لزوج ابنة الشهيد يوم زفافه، وفقدان الإقامة وبالتالي البيت، وأيضًا فقدان الأهل المنشغلين باسترداد جثمان الابن على حساب بقية العائلة.
هذا النوع من الفقدان، الفقدان السياسي، المعلّق، والممتدّ والمؤجّل وغير المكتمل، هو أولاً فقدان، كما تصفه عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، صعب ومؤلم جدًا، بسبب ثِقل "التابوت الفارغ" المحمول على كاهل أُسر الشهداء، بعكس التوابيت الفارغة في الانتفاضة الأولى والتي كانت تجوب شوارع القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، على أكتاف المشيّعين، لإتمام طقوس الحداد، ولو بشكل رمزي. وهو فقدان يختلف الموت فيه عن الموت العادي، لأسباب عديدة أجملَها أهالي الشهداء في شهاداتهم المختلفة. هو موتٌ مختلفٌ لعدم التيقّن لحالة الموت. عدم اليقين هذا تعيشه معظم الأسر، خاصّة وأنّه لم تحصل أي أسرة على ورقة رسميّة تؤكّد لهم حالة الوفاة، والاحتلال لا يصدر شهادات وفاة لهؤلاء الشهداء، وهو يرفض منح الأهل فرصة التعرّف على جثامين أبنائهم، لحظة الاستشهاد، ما عدا في حالة الشهيد الطفل حسن مناصرة الذي تمّ استدعاء والده لهذا الأمر، أو في ثلاجات التجميد، ويرفض إجراء فحص الحمض النووي. لوالدة الشهيد عبد الحميد أبو سرور، قال أحد جنود الاحتلال، بعد مداهمة بيتهم: "بكّير على العزا. سألته:"عزا مين؟ قال لها:"ابنك عبد الحميد نص شهيد!" وهي، كغيرها من أمّهات الشهداء، تقول: "بظل في واحد بالمية احتمال انه ابنّا لساته عايش". عدم رؤية الجثمان يزيد من مخاوف الأهل بأنّ ابنهم تمّ اختطافه وهو مصاب، وقد يتمّ إعدامه بعد ذلك بدم بارد، ومنع سلطات الاحتلال من تشريح الجثامين بعد تسليمها يزيد من هذه الشكوك، بالإضافة إلى أنّ حالات الإعدام الميداني شاهدناها جميعًا على شاشات التلفاز في العديد من الحالات، كما في حالة الشهيد الطفل نسيم أبو رومي والشهيد الطفل حسن مناصرة. وعدم رؤية الجثمان يزيد من حالة الانتظار.
هو موتٌ مختلف أيضًا بسبب المخاوف التي تصيب العائلة على مصير الجثمان، فهو "في الثلاجة، لكن هل هو بارد أم ساخن؟ أي لون أخذ؟ كيف يمكن أن نخفّف عليه؟"، هذه كلّها هواجس تبدو غير منطقية ولا عقلانية، لكن هذا ما يخطر على بال أهالي الشهداء، لدرجة أن والدة الشهيد بهاء أصبحت تتجنّب الاقتراب من الثلاجة، وإخراج قطعة لحم مجمّدة تذكرها بابنها وتخيفها: "هل ابني أصبح شيئًا مثل هذه؟". هنالك أيضًا الخوف من العبث بالجثمان ومن سرقة أعضائه، وهو خوف يغذّيه سلوك الاحتلال وشروطه في كيفية تسليم الجثمان وإجراءات الدفن، بحيث يصبح من شبه المستحيل التأكّد من هذا الموضوع أو نفيه (عليان، 2018)، وهناك العديد من الدراسات والدلائل التي تشير إلى أن الاحتلال قام بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء (عودة الله، 2016؛ عليّان، 2018). في هذا السياق، أحد أبناء عم الشهيد الطفل نسيم، خلال المقابلة مع عائلة الشهيد عبّر عن قلقه من إمكانيّة قيام الاحتلال بسرقة الأعضاء من جسد الشهيد قائلًا: "نسيم كان طفل، يعني صحته مليحة كيف بدّك أقتنع إنه ما راح يسرقوا أعضاء من جسمه؟!".
وهو موتٌ مختلف بسبب الحالة الاجتماعية للعائلة، التي يمكن تلخيصها بأنها حالة عزاء دائم، ولا يمكن العودة للحياة الطبيعية، ما قبل الاستشهاد، فإذا ما ذهبت إلى جنازة فسوف تتذكّر ابنك الشهيد المحتجز، وإذا ما ذهبت إلى فرح، فلن تفرح، لأنّ ابنك في الثلاجة. وكثير من الأمّهات انقطعن كليًا عن المناسبات الاجتماعية. إحدى الأمّهات من القدس، تعبّر عن هذه الحالة من الفقدان قائلة: "نعيش في حالة موت سريري" (عمر، 2017، ص 80). على العكس من الموت العادي، حيث يُفتح بيت العزاء لثلاثة أيام وينتهي، هنا، في الموت المعلّق، الأسرة لا تعرف إن كانت ستفتح بيت العزاء وكم من الوقت سيبقى مفتوحًا؟ فمثلا، حين زرت أسرة الشهيد نسيم أبو رومي، بعد سبعة عشر يومًا من الاستشهاد، كان بيت العزاء ما زال مفتوحًا. والأمهات يبقين في عزاءٍ دائم، حتى وإن بدّلن الملابس السوداء بملابس عاديّة، فلا شيء يفرحهنّ. ذوو الشهداء عمومًا كأنّهم يلبسون قناعًا كلّ صباح، قبل الخروج من البيت لمواجهة العالم، لكن في كثير من الأحيان يكون هذا القناع خانقًا. والد الشهيدة مرام حسّونة قال إنّ "احتجاز جثمانها كان مؤلمًا جدًا لنا. لم تكن لدينا أيّة حياة عندما كان جثمانها محتجزًا" (دراغمة، 2016، ص 37).
وهو موتٌ مختلف لقيمة القبر لدى ذوي الشهداء، فالقبر العادي يصبح نقيضًا للقبر المفتوح، وهو المكان الذي يمكن الذهاب إليه لبثّ الشكوى ولمناجاة روح الفقيد، ولإغلاق دائرة الحزن. أسرة الشهيد عبد الحميد أبو سرور جهّزت لابنها قبرًا، ما زال مفتوحًا حتى اليوم، في انتظار تحرير الجثمان، وحين تضيق الدنيا في وجه والدة الشهيد تذهب لترتاح عند القبر، لكنّ رؤية القبر مفتوحًا يؤلمها ويذكّرها بأنّه ما زال عليها واجب الأم تجاه الابن، وهو استعادة الجثمان وإغلاق القبر. تقول أزهار أبو سرور إنّ إحدى أمهات الشهداء قالت لها: "نيّالك راح تحتضني ابنك مرّة ثانية"، فأجابتها، "نيّالك إنت، على الأقل عندك قبر تزوريه"، لكن والدة الشهيد باسل الأعرج قالت لها: "أنا بفهمك، حجزوا ابني تسعة أيام واحترق قلبي عليه، وما ارتحت إلا لدفنّاه". صمود، شقيقة الشهيد الطفل نسيم أبو رومي، في الصف السابع، تقول بكلماتها البسيطة: "إش بدّك أحكيلك عن نسيم؟ عن سنة ما بخلص أشياء عن نسيم. بشتقله وبعيّط، بس مش قدّام أهلي ولا إمي، بتصير تعيّط معي. أصعب إشي هو أنّه نسيم مش موجود، وإنهم ما قبلوا يسلمونا جثمان نسيم. لمّا يسلمونا الجثمان بصير كل يوم أروح على قبره على الأقليّة، وبقرأ له الفاتحة". قلت لها: "وبنزرع وردة.."، قالت: "مش وردة.. ورود".
وهو موتٌ مختلف أيضًا بسبب المفاوضات التي تدور مع الاحتلال، وحالة الانتظار التي لا تنتهي، لتسلّم الجثمان. هذا الموضوع لوحده يُشكّل، على حدّ تعبير عليّان، "أزمة نفسيّة حقيقيّة"، فعائلته فتحت أربعة قبور، في أكثر من مقبرة، وهي تفاوض الاحتلال لاستعادة جثمان الشهيد بهاء. في المفاوضات سلطات الاحتلال تلعب بأعصاب عائلة الشهيد وتستفزّهم، وتضع شروطًا لمنع تكريم الشهيد، وأيضًا لمنع تشريح الجثمان والكشف عن أي انتهاكات (سرقة أعضاء محتملة) ضدّه، وحالة التجميد تصعّب من عملية الدفن، وتمنع من توديع الشهيد كما يجب ومن احتضانه أو حتى من تقبيله، ممّا يزيد من معاناة الأسرة ومن لوعتها. مناصرة، والد الشهيد الطفل حسن، رفض تسلّم جثمان ابنه الشهيد لأنّ الاحتلال أعاده كتلة من الجليد، ولم يلتزم بالاتفاق مع العائلة بأن تتمّ إذابته قبل التسليم. يقول طه قطاني، والد الشهيدة أشرقت، "إنّ الشروط الاسرائيلية هدفها تكريس فكرة لدى الناس أنّ الشهيد لا كرامة له، يُدفن في الليل، من دون حضور ووداع جماهيريين". ويتابع: "أهمّ خاصيّة للشهيد هو التكريم الشعبي عبر تشييع جماهيري واسع"، (دراغمة، 2016، ص 38)، والاحتلال يريد أن يحرم الشهيد وعائلته من هذا التوديع.
الفقدان والفقدان المُلتبِس
هنا، في حالة "القبر المفتوح" والفقدان "المعلّق" والممتد، نجدّ أنّ أدبيّات الفقدان، كما نعرفها في مجال العلوم الاجتماعية والنفسيّة، لا تعطي هذه الحالة حقّها، خاصة حين تتعاطى، هذه الأدبيّات، مع مراحل الحداد وتقسمه إمّا "إلى ثلاثة مراحل نموذجيّة: 1- مرحلة النكران: لا يمكن أن يكون هذا صحيحًا، 2- مرحلة الحزن: أشعر بالأسى، و3- مرحلة إعادة التنظيم: حان الوقت لأمضي في حياتي" (باتِل، 2008)، وإمّا إلى خمسة مراحل، كما في نموذج كيوبلر- روس
(Kübler-Ross Model: Five Stages of Grief):1- الإنكار: "أنا بخير"، "لا يمكن أن يحدث هذا لي"؛ 2- الغضب: "لمَ أنا؟"، كيف يحدث هذا لي؟، "مَن الملام على ذلك؟؛ 3- المساومة: "فقط دعني أعيش لرؤية أطفالي يتخرّجون"، "سأفعل أي شيء من أجل بضع سنوات أخرى"، "سأمنح ما تبقّى من حياتي إذا..."؛ 4- الاكتئاب: "أنا حزين جدًا، لِمَ أزعج نفسي لأيّ شيء"، "أفتقد مَن أُحب، لِمَ الاستمرار؟"؛ 5- التقبّل: "سيكون كلّ شيء على ما يرام"، "لا أستطيع المقاومة، من الممكن أن أستعدّ لها على أفضل وجه" Kübler-Ross, 1969; 2005)).
هذه النماذج والمراحل قد تصف الكثير من حالة الفقدان مع "القبر المفتوح"، والتي قد تستمرّ لأشهر أو لسنوات طويلة، لكنّها ليست كافية ولا تعطي هذه التجربة حقّها؛ فما يميّز هذا الفقدان هو أنّه "فقدان مُلتبِس"Ambiguous Loss (Boss, 1999)، فقدان غير واضح المعالم وغير مكتمل، وهو نوعان. النوع الأول، رحيل دون وداع، حينما يتمّ الإعلان عن الوفاة أو فَقد شخص ما دون وجود للجثمان، في الحروب وفي عمليات الاختطاف وفي التطهير العرقي، إلخ (الصليب الأحمر الدولي، 2007)، فيكون الفرد غائبًا جسديًا، حاضرًا نفسيًا، وحضوره (في حالة الشهداء المحتجز جثامينهم) يطغى على كلّ شيء آخر في الحياة، مع بقاء أمل ولو بسيط جدًا أنّه قد يكون على قيد الحياة. أمّا النوع الثاني، وداعٌ دون رحيل، يكون الفرد فيه حاضرًا جسديًا وغائبًا نفسيًا وعاطفيًا (كحالات الألزهايمر، والإدمان، والاكتئاب الشديد والانشغال الكلّي في قضيّة استعادة الجثمان)، فبالرغم من حضور الشخص جسديًا، إلّا أنّه لا ينتبه أو لا يهتم للمحيطين به ولا يتفاعل معهم (Boss & Yeats, 2014; Boss, 2017).
لدى أسر الشهداء المحتجزة جثامينهم فإنّ الفقدان المُلتبِس من النوع الأول حاضرٌ وبوضوح، فالحضور النفسي للشهيد يظلّ مسيطرًا على المشهد، بينما الجسد غائب في ثلّاجات الاحتلال. وقد يكون الفقدان المُلتبس من النوع الثاني مزامنًا للأول، حيث إنّ انشغال مقدّم/ة الرعاية الكامل بكيفيّة استعادة جثمان شريك حياته أو ابنته أو أخيه يضعه، من حيث لا يعلم، في فقاعة تفصله عن محيطه وعن مسئوليّاته وعن حياته السابقة، ولا يرى فيها سوى انشغاله بقضية الفقدان هذه، فيمسي حاضرًا جسديًا غائبًا نفسيًا، من منظور مَن يُعيلهم ومَن يقدّم لهم الرعاية، إلّا أنّ النوع الأوّل من الفقدان المُلتبس هو الأقوى والذي تعاني منه الغالبية العظمى من عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم.
الحاجة لدفن الجسد ليست ذات أهمية متواضعة، كما يبدو للمجتمع الذي يفقد صبره بسرعة ويتوقّع من عائلة الفقيد التماسك والمضيّ قدمًا، إلى جانب السياق الثقافي الذي يرى في الدفن تكريمًا للفقيد ومتطلّبًا حتى ترقد روحه في سلام. إنّ رؤية جسد الفقيد تساعد في تقبّل غيابه، وفي تجاوز حالة الإنكار، والحاجة الأوليّة لوداع الفقيد ولو بكلمة واحدة أخيرة تشتدّ إلحاحًا بازدياد قوّة الرابطة التعلّقية بين الفقيد والفاقد (Boss, 2002). يرى بولبي (Bowlby, 1969)، صاحب الإسهام النظري حول الارتباط وأنماط التعلّق، أنّه من المستحيل أن يستطيع الفرد الدخول في مرحلة انفصال ما لم يشارك في طقوس التأبين والجنازة ((Boss, 2002.
ومن حيث ترى الأدبيّات أن العائلات التي تستطيع المرور عبر أزمة الفقدان المُلتبس هذه بالشكل المرجوّ، تنجح في هذا من خلال اعتناقها لإحدى الفكرتين: "الشخص ميّت بلا شك، لن أستطيع الوصول إلى جسده، لكنّه سيظلّ حاضراً معنا بشكل مجازيّ ما منطلقاً من أنّ روحه قد انفصلت بالفعل عن جسده الغائب وبإمكانها أن تكون بالجوار" أو "يجبّ عليّ أن أمضي في حياتي، أن أعيد تشكيل الأسرة وتوزيع الأدوار بناء على غيابه، لكنني سأظل آمل أن أتعثّر بجثته بصدفة عجيبة وأتمكّن من وداعه"، حيث تساعدها هذه الطريقة المثاليّة من التفكير في شرعنة البدء بعملية الشفاء والتعافي من الفقدان، دون الشعور بالذنب إزاء فقدان الأمل في استعادة الجسد وإقامة طقوس الوداع التي تليق بالفقيد، ويرى الكثيرون أن إقامة طقوس مجازيّة للتأبين وللدفن تشكّل خيارًا جيّدًا حتى يستطيع أفراد العائلة استيعاب حالة الفقدان (المصدر السابق).
خصوصيّة الحالة الفسطينيّة
إلّا أنّ الحالة الفلسطينية هنا تمتلك خصوصية مختلفة، فالجسد ليس مكدّسًا في مكان ما مع مئات من الجثث الأخرى مغيّبة المعالم، وليس غارقًا في محيط أو في مكان ناءٍ مجهولٍ بالكليّة، وليس مُغيّبًا في أقبية مظلمة أو في سراديب سريّة تحت الأرض قد يتمّ افتضاح أمرها في أيّ وقت، وإنّما تتحفّظ عليه وتحتجزه دولة الاحتلال، دون أي اعتبار لكرامة الميّت ولحرمته، وفي تحدّ واضحٍ لكل القوانين الدولية وللمواثيق المتعارف عليها، ذات الشأن، من منطلق عقاب وإذلال الشهيد وذويه؛ فقبل أن نطالب عائلات الشهداء بتبني التفكير السابق، والتسليم بأنّ استعادة الجسد أمرٌ محال، وبأنّ إعادة تشكيل أدوار الأسرة وحدودها وقواعدها أولى من بحث الطرق لاستعادته، علينا أن نراعي خصوصيّة الحالة، بأن الأفراد يرون أنّهم في تحدٍّ، ولا يمكن نعت هذا الإدراك بأنّه مشوّه، حيث إنّ استعادة الجسد تُعدّ انتصارًا، وقد تمكّن آخرون من تحقيقه بالفعل. العائلة، إذن، تشعر بالمسئولية، وبأنّ استعادة الجسد واجب لا يمكن التقصير إزاءه، وربّما يخالجها شعور بالذنب إذا ما عجزت عن مرادها، مضافًا إلى الشعور بالهزيمة، وهي مشاعرٌ مناقضة بالكليّة لما يتوقّعه العُرف المجتمعيّ من شعور بالفخر وبالألم الممزوج بالابتهاج، والمرافقان عادة لأسر الشهداء.
ما يزيد من خصوصيّة الحالة الفلسطينية، في هذا النوع من الفقدان، احتجاز الجثامين في ثلاجات التبريد لدى الاحتلال في درجات حرارة منخفضة جدًا، هو التشوّه الذي يطرأ على جسد الشهيد نتيجة التجميد، والتعقيدات المتعلّقة بذلك وقت تسليم الجثمان؛ حيث إنّ موضوع التسليم هو أصعب من الفقدان ذاته، كما عبّر عن ذلك أهالي الشهداء الذين عاشوا تجربة تسلّم الجثمان وهو في حالة تجميد، أو أولئك الذين تسلّموه غير مجمّد، بعد أن اشترطوا ذلك على سلطات الاحتلال. يصيب جسد الشهيد، بعد أن يكون محتجزًا لأشهر في ثلاجات الاحتلال، تحت درجات حرارة تصل إلى 40 درجة ما دون الصفر، تشوّهات كبيرة وتغيّر ملامحه، وعندما يتمّ تسليمه مجمّدًا فسوف يكون من الصعب على عائلته أن تودّعه كما تريد، وأم الشهيد لن تستطيع أن تطبع قبلة على خدّه، لأنه كتلة من الجليد، بالأضافة إلى الصعوبة في إدخاله القبر، إما لثقله أو لأنّه من الصعب تحريك أطرافه لدفنه كما يجب، وقد حصل أن سقطت يد شهيد من مكانها، في مخيّم قلنديا، في محاولة لجعل الجثمان ملائم لدخول مثواه الأخير. كما أنّ هنالك العديد من الشهادات التي تُعبّر عن الرعب، المرافق لتسلّم الجثمان في حالة التجميد، من أن يسقط الجثمان ويتكسّر إلى شظايا كقالبٍ من الزجاج. بعض الأهالي انتظروا ليومين قبل أن يستطيعوا دفن شهيدهم، وآخرون حاولوا لساعات طويلة إذابة الجليد عن طريق سكب الماء الساخن على الجثمان، حتى يطرى وجهه لتقبيله وتوديعه قبل الدفن.
التدخّل النفسيّ
من قراءة واقعيّة ومراعاة لحساسيّة الحالة التي بين أيدينا، يصعب على أي أسرة الاستفادة من تدخّلات نفسيّة لعبور مراحل الفقدان، ما لم تتزامن بخطوات واضحة مرتبطة بمحاولات استعادة الجثمان، وربما الانتصار لقضية احتجاز الجثامين ككلّ فيما بعد، بما يمنحهم معنىً للنضال من أجله، لِألّا تتكرر تجربتهم المؤلمة جدًا مع الآخرين، ولينتصروا مجدّدًا ضد من أراد إذلالهم وفقيدَهم.
ولا بدّ للتدخّلات النفسيّة من أن تفتح المجال للحديث عن كيفيّة استيعاب كل فرد من العائلة لهذا الحدث الجَلل، بتنبّؤاتهم، وبأمنياتهم، وبمشاعرهم المتناقضة، وشرعنة كل هذه الأفكار والمشاعر وتقبّلها، والتأكيد على أنه من الطبيعيّ أن يتبنّى أفراد العائلة المختلفين تصوّرات ومشاعر مختلفة، يؤمن أحدهم بضرورة استعادة الجثمان، ويحاول آخر تقبّل فكرة أن هذا من الممكن ألّا يحدث، ويشعر أحدهم بالغضب، وآخر بالعجز، وبالذلّ وبالألم، أو بكل الأحاسيس والمشاعر مجتمعة.
الفكرة الثابتة، بأن طقوس الحداد لن تقام ما لم تتسلّم العائلة جسد فقيدها، يمكن العمل على حلّ وسطيّ لها في هذه الحالة، من خلال تأجيل الجنازة كمظهر للتحدّي وللإصرار على الحق باستعادة الجثمان. من الممكن أن يترافق هذا الحلّ الوسطي مع محاولات العائلة للحديث عن ألمها وعن فَقدها، وإعادة تشكيل الأدوار الأسرية لا تزال مطلوبة أيضًا، حيث إنّ الإصرار على أن الشخص لم يُفقد بعد يضع العائلة في تجميد لمشاعر الفقدان، وللحياة ككل، الذي من المرجّح أن يستمر طويلًا. إنّ إيجاد نوع من التوازن بين ما يمكن فعله لاستعادة الجثمان، وما يمكن فعله لعبور الأزمة في الوقت ذاته، من خلال وضع نموذج تدخّل نفسيّ واضح مع أُسَر الشهداء المحتجزة جثامينهم، اعتمادًا على مواءمة النماذج النفسية المعروفة وفقًا للتجربة الخاصة لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، هو أمرٌ محبّذٌ بلا شكّ.
أحد هذه النماذج قد يكون النموذج ثنائي المسار للثّكل The Two-Track Model of Bereavement (Rubin, 1981)، وهو نموذج نظري الذي يصف الفقدان على أنّه تجربة تشمل مسارين منفصلين، لكن مكمّلًا أحدهما الآخر: تأثير الفقدان على الأداء العام للفاقد، من جهة، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفقيد، من الجهة الأخرى. المسار الأول في هذا النموذج ينظر إلى الفقدان كحدث غير عادي، له عواقب جسديّة وسلوكيّة وفكريّة وعاطفيّة تؤثّر على مُجمل نواحي حياة الثاكل، في أشكال وفي درجات مختلفة؛ أمّا المسار الثاني فيتطرّق لاستمراريّة العلاقة مع الفقيد، ولمعالجة "قصّة الموت" في السرد الذاتي للثاكل. بكلمات أخرى، فإنّ المسار الأوّل يتطرّق عمليًا إلى الجانب الأدائي في النواحي البيولوجيّة والنفسيّة والاجتماعيّة كافّة؛ ويشمل مشاعر الحزن والاكتئاب والشعور بالذنب والأفكار بعدم جدوى الحياة وبعدم القدرة على العمل وعلى التعلّم وعلى بذل الطاقة في النواحي الحياتيّة المختلفة. المسار الثاني يتناول جانب العلاقة المستمرّة والمميّزة للشخص مع الفقيد، ويشمل هذا المسار العالَم الداخلي للثاكل واستجاباته العاطفية الإيجابيّة منها والسلبيّة مع الذكريات تجاه الفقيد بما فيها مدى الانشغال به، ومدى الذكريات والأفكار، والامتناع عن التجاوب العاطفي بخصوص الفقدان، والمشاعر تجاه الفقيد الإيجابيّة منها والسلبيّة، والاستجابة العاطفية للذكريات (Rubin, 1999).
بالإضافة لذلك، فإنّ الدعم الاجتماعي الذي تحظى به العائلات الفاقدة من العائلات التي مرّت بحالات شبيهة سابقة، لأهميته، من الممكن استثماره من خلال تكوين مجموعات دعمٍ منظّمة، تفوق فاعليّتها المبادرات الفرديّة الارتجاليّة.
كما أنّ جزءًا من مسؤوليّة الاختصاصيّين النفسيّين والاجتماعيّين الفلسطينيّين يتمثّل بدراسة هذه التجربة بالعمق الكافي، وبطرح التدخّلات الممكنة الملائمة لخصوصيّة هذه الحالة، وبتسليط الضوء على الأبعاد النفسيّة لها ونشرها في المجلّات العلميّة، امتدادًا لمحاولات هذا الشعب بالانتصار لقضاياه العادلة، ونشر روايتنا الخاصة والصادقة حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
في النهاية، يمكن تلخيص الآثار النفسيّة لاحتجاز جثامين الشهداء كعقوبة جماعية عبر تعداد "مراحل الوجع"، كما وصفها والد أحد الشهداء، ونقلها عنه والد الشهيد بهاء عليان:
• يعدمون الشهيد، نتوجّع،
• يحتجزون جثمانه، نتوجّع جدًا،
• يسلّمون الجثمان، نتوجّع جدًا جدًا،
• وعندما يعيدون ملابسه، نتوجّع جدًا جدًا جدًا.
"هذه هي مراحل الوجع ودرجاته، وبين المرحلة والأخرى وقتٌ قد يطول أو يقصر".
بهذا التلخيص تكمُن خصوصيّة الحالة الفلسطينية في "الفقدان المُلتبِس"، وهي خصوصيّة بحاجة إلى فهمٍ أعمق وإلى دراسةٍ أوسع وأشمل، بكلّ تأكيد.
المراجع العربيّة:
أبو بكر، خولة. (2004). النساء والنزاع المسلّح والفقدان: الصحّة النفسيّة للنساء الفلسطينيّات في المناطق المحتلّة. مركز الدراسات النسوية، القدس.
أبو غوش، حنان. (2013). دراسة حول أثر هدم المنازل على أدوار وعلاقات النوع الاجتماعي. طاقم شؤون المرأة، رام الله.
اسبنيولي، هالة، وعويضة، ساما. (2007). تجربة النساء الفاقدات في الدعم النفسي المتبادل. مركز الدراسات النسوية، القدس.
باتِل، فيكرام. (2008). كتاب الصحة النفسية للجميع "حيث لا يوجد طبيب نفسي". الطبعة العربيّة المعدّلة الأولى. ورشة الموارد العربية. بيروت.
برنامج حماية الأسيرات والمحتجزات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية. (2016). التعامل مع الأسيرة في ما بعد الأسر. المركز الفلسطيني للإرشاد. القدس.
حسنين، سهيل. (2010). تجربة من فاقدة إلى فاقدة من منظور الدعم الشمولي. مركز الدراسات النسوية، القدس.
حسنين، سهيل. (إعداد). (2014). دليل الممارسات المُتميّزة لـ "نهج من فاقدة لفاقدة". مركز الدراسات النسوية، القدس.
حسنين، سهيل. (2015). المرأة الفلسطينية والفقدان القائم على الاحتلال: دراسة في منطقة القدس ومحافظتي سلفيت والخليل بمناطق ج". مركز الدراسات النسوية. القدس.
الحملة الدوليّة ضد سحب حق الإقامة من الفلسطينيين في القدس. (2015). الائتلاف من أجل القدس. القدس.
الحملة الوطنيّة لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين. (2016). لنا أسماء ولنا وطن. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. القدس – رام الله.
دراغمة، محمّد. (2016). "احتجاز الجثامين سياسة اسرائيلية متوحّشة وفاشلة". مجلّة الدراسات الفلسطينية: عدد 107: 037-044.
دوابشة، عز الدين. (2017). الضغوط النفسية واستراتيجيّات مواجهتها لدى أسر الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة القدس المفتوحة. القدس.
سرور، روني. (2002). الحاجز الأمني وتأثيره النفسي، المركز الفلسطيني للإرشاد. القدس.
سرور، روني. (2009). آثار سياسة هدم المنازل على الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم، المركز الفلسطيني للإرشاد. القدس.
طقاطقة، عيسى. (2012). العلاقة بين التوافق النفسي والاجتماعي للنساء الفلسطينيّات الفاقدات لأقربائهنّ الشهداء في الضفة الغربية والمحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام في ضوء بعض المتغيّرات. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة القدس. القدس.
ظاهر- ناشف، سهاد. (2016). "الاعتقال الإداري للجثامين الفلسطينية: تعليق الموت وتجميده". مجلّة الدراسات الفلسطينية: عدد 107: 019-033.
عبد الحميد، مهنّد. (2016). "الموت المزدوج أو التوحّد مع المحتل في الموت". مجلّة الدراسات الفلسطينية: عدد 107: 045-054.
عليّان، محمّد. (2018). احتجاز جثامين الشهداء من منظور القانون الدولي (نموذج مقابر الأرقام والثلاجات) (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة القدس. القدس.
عليّان، محمّد. (إعداد). (2019). البهاء باقٍ فينا ومعنا. الرعاة للدراسات والنشر وجسور ثقافية للنشر والتوزيع. رام الله – عمّان.
عمر، إكرام. (2017). "المرأة الفلسطينية بين ألم الفقدان وقهر الاحتلال". مجلّة سياسات: عدد 41: 76-86.
عودة الله، خالد. (2018). "حول التمثيل بجثامين الشهداء باحتجازها"، موقع باب الواد https://www.babelwad.com/ar/
فريدمان، س. ه.، وشستك، م. و. (2013). الشخصيّة: النظريّات الكلاسيكيّة والبحث الحديث. ترجمة أحمد رمو. المنظمّة العربيّة للترجمة. بيروت.
فوكو، ميشيل. (1990). المراقبّة والمعاقب: ولادة السجن. ترجمة علي مقلد. مركز الإنماء القومي. ىبيروت.
كريّم، عوني. (2007). "آفاق: مشروع تدخّل في حلات الطوارئ". مجلّة همسة: عدد 7: 17-21.
كناعنة، مصلح، ونتلاند، ماريت. (2003). أعماق الذات المنتفضة، الجمعية النرويجية الفلسطينية – نوردباس وجمعية البلد الثقافية، حيفا.
اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر. (2007). الأشخاص المفقودون مأساة منسيّة. جنيف: اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر.
المركز الفلسطيني للإرشاد. (2009). بيوت مهدمة: معالجة آثار هدم المنازل على الأطفال الفلسطينيين والأسر الفلسطينية. إصدار المركز الفلسطيني للإرشاد ومؤسسة إنقاذ الطفل ومؤسسة التعاون. القدس.
منظمة أطباء بلا حدود، عقاب جماعي https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/qb-jm-yw/
النشاشيبي، رنا، وبوشية، نسرين، وترزي، لمى. (2005). الأعراض النفسية الناجمة جراء التعرض لجدار الضم والتوسع في قرى محافظة قلقيلية. المركز الفلسطيني للإرشاد. القدس.
النشاشيبي، رنا، وجحجوح، خالد. (2000). الواقع السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي وتأثيره على الصحّة النفسية للشباب الفلسطيني. المركز الفلسطيني للإرشاد. القدس.
المراجع الأجنبيّة:
Boss, P. (1999). Ambiguous loss. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Boss, P. (2002). “Ambiguous loss: working with families of the missing”. THE LANCET Supplement. 360, pp. 39-40.
Boss, P. & Yeats, J. (2014).“Ambiguous loss: A complicated type of grief when loved ones disappear”. Bereavement Care.Vol. 33 No 2, pp. 63-69.
Boss, P. (2017).“Families of the missing: Psychosocial effects and therapeutic approaches”. International Review of the Red Cross. 99(2), pp. 519-534.
Broadhead, R. S. & Rist, R. C. (1976). “Gatekeepers and the Social Control of Social Research”. Social Problems, Vol. 23, No. 3, pp. 325-336.
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. New York: Basic B00k.
Kübler-Ross, E. (1969). On Death and Dying, Routledge.
Kübler-Ross, E. (2005). On Grief and Grieving: Finding the Meaning of Grief Through the Five Stages of Loss, Simon & Schuster.
Rubin, S. (1981). A Two-track Model of Bereavement: Theory and research. American Journal of Orthopsychiatry, 51(1), pp. 101-109.
Rubin, S. S., (1999). The Two-track Model of Bereavement: Overview, retrospect and prospect. Death Studies, 23(8), pp. 681-714.
Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On depression, development, and death. San Francisco: Freeman.